تستعرض منهجية التكوين في الإبداع كيف يمكن للتكوين أن يعزز الكفاءات ويحقق الابتكار في المنظمات. هل ترغب في اكتشاف الاستراتيجيات الفعالة التي تساهم في تحسين أداء الأفراد في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية؟
يتناول هذا البحث أهمية التكوين في تنمية الكفاءات وتحقيق الإبداع في المنظمات، حيث يعتبر التكوين وسيلة أساسية لتحسين أداء الأفراد والجماعات في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
جامعة سعد دحلب – البليدة –
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
إقتصاديات المعرفة و الإبداع
الممارسة و التحديات
خلال الفترة : 17-18 أفريل 2013
مداخلة تحت عنوان:
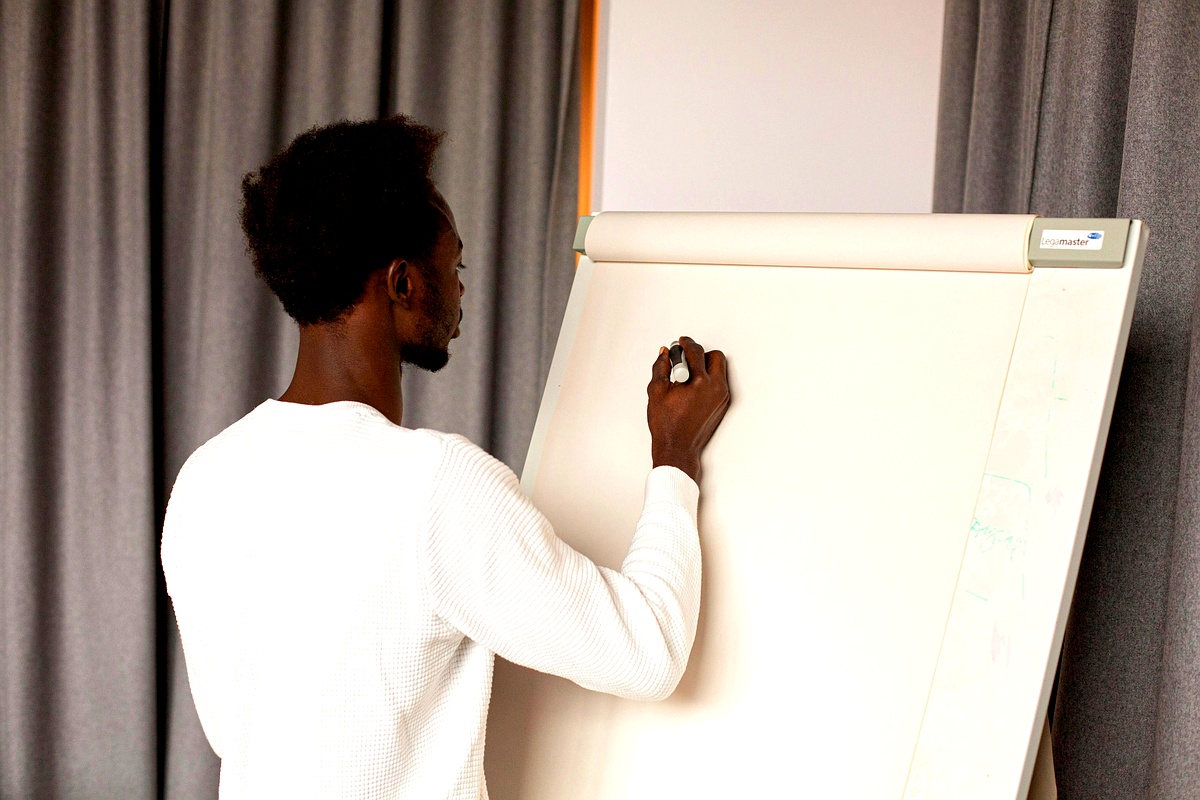
“دور التكوين في تنمية الكفاءات وتحقيق الإبداع”
من إعداد:
أ.د شنوفي نور الدين & أ. مرزوقي عبد المؤمن
مدرسة الدراسات العليا التجارية & جامعة البليدة
ملخص:
أصبح التكوين بمختلف أنواعه خيارا أساسيا للعاملين الراغبين في اكتساب المزيد من المعلومات وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، في ظل مختلف التطورات الثقافية، الاقتصادية والتكنولوجية، فالتكوين عنصر رئيسي في تنظيم الموارد البشرية، فهو من الآليات الأساسية لتنمية كفاءات الأفراد والجماعات، وإحداث الإبداع على كل المستويات.
يجب تصور التكوين حسب الأهداف التي تسعى إليها المنظمة، لأنه لا يمكننا الحكم على أثاره وعوائده إلا عن طريق النتائج المحققة، فهو إذن الوسيلة الأفضل لتنمية الكفاءات وتحقيق الإبداع على مستوى المنظمة، والذي يمكن أن يشكل استثمارا مربحا ومولدا للقيمة.
في القديم كانت المنظمة تراهن على تنمية الكفاءات والإبداع على المستوى الفردي فقط، الآن أصبحت تعترف بأنه من أجل ضمان مستويات عالية من الأداء وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة، يجب الاعتماد، ليس فقط على تنمية كفاءات وإبداع العاملين، وإنما تنمية الكفاءات والإبداع على المستوى الجماعي والاستراتيجي.
الكلمات الدالة: التكوين، الكفاءات، الإبداع، التنمية.
مقدمة:
يعتبر المورد البشري حجر الزاوية والمفتاح السحري في المنظمات الحديثة، فعليه تبنى كل السياسات والاستراتيجيات وهو شئ طبيعي نظرا لدوره في تحقيق أهداف المنظمة، فهي تسعى دائما لإدارته وتنميته و وتكييفه مع التغيرات في بيئة العمل والتحسين المستمر لأدائه.
وقد أصبح مصطلح التكوين ملازما لمصطلح التنمية أو مرادفا له في بعض الأحيان، فهو الوسيلة الفعالة التي تلجأ إليه معظم المنظمات الهادفة لتنمية كفاءاتها وتطوير أدائها وتحقيق الإبداع في كل مستوياتها.
تنتهج المنظمة التكوين كعملية متسلسلة، مستمرة ومنهجية وتقوم بإدارة هذه العملية للوصول إلى أهدافها، و لب هذه الأهداف هو تنمية المورد البشري بتنمية كفاءاته ودفعه نحو الإبداع، والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف العليا للمنظمة والتي تتمثل في تحقيق إبداع تنظيمي وميزة تنافسية مستدامة وتحقيق الريادة في السوق.
تتمحور دراستنا لهذا الموضوع حول الإشكالية التالية: كيف تتم تنمية الكفاءات وتحقيق الإبداع عن طريق التكوين؟
ومن أجل الإجابة عن هذا التساؤل قمنا بتقسيم دراستنا إلى أربعة محاور رئيسية وهي كما يلي:
- التكوين في المنظمة
- إدارة الكفاءات في المنظمة
- الإبداع في المنظمة
- دور التكوين في تنمية الكفاءات وتحقيق الإبداع.
أولا: التكوين في المنظمة
- مفهوم التكوين:
يعرف lakhdar sekiou التكوين بأنه ”مجموعة من الأفعال، الوسائل، الطرق والدعائم التي تحث العمّال على تحسين معارفهم، سلوكاتهم، إتجاهاتهم وقدراتهم الذهنية اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة؛ الشخصية والاجتماعية، مع عدم إهمال الانجاز الملائم لوظائفهم الحالية والمستقبلية” .[1]
”التكوين هو عملية تعلم سلسة من السلوك المبرمج، أو بمعنى أخر عملية تعلم مجموعة متتابعة من التصرفات المحددة مسبقا، والتكوين هو تطبيق المعرفة، وهو يمكّن الأفراد بالإلمام والوعي بالقواعد و الإجراءات الموجهة والمرشدة لسلوكهم”. [2]
كما يعرف التكوين أيضا بأنه ”تغيير في سلوك الفرد لسد الفجوات المعرفية والمهارية والاتجاهية بين الأداء الحالي والأداء على المستوى المطلوب”. [3]
وعرفه Jaques Soyer أنه ”هو الوسيلة التي تستطيع أن تخدم أهداف جد متنوعة، كل نوع من هذه الأهداف يتعلق بتكوين خاص يتميز بقواعد تسيير خاصة”. [4]
وأشار dimitri weiss أن “التكوين يجب أن يسمح للفرد بإيجاد حلول للمشاكل التي تعترضه في ظروف العمل وإحداث التغيير الذي يراه مناسبا “.[5]
من خلال هذه التعاريف يمكننا أن نستنتج أن التكوين وسيلة وليس هدفا في حد ذاته تلجأ إليه المنظمة من أجل تحقيق أهدافها، وهو عملية منظمة و مستمرة تهتم بالفرد وتنمية مهاراته و قدراته وتغيير اتجاهاته من أجل تحسين أدائه وأداء المنظمة ككل. وكما أشار soyer أن أهداف المنظمة متنوعة، ولكل نوع من هذه الأهداف تكوين يميّزها. التكوين يساعد على تفعيل عملية التغيير في المنظمة ويسهل تقدم العملية. وأخيرا وجوب الاهتمام بتخطيط التكوين، فالتكوين إستثمار له تكلفة وينتظر منه عائدا، لذا فعلى المنظمة أن تضمن تحقيق التكوين لأهدافها وأهداف الجماعة والفرد.
- أهمية التكوين:
كل التطورات والتغيرات التي تشهدها بيئة المنظمة تجعل من التكوين وسيلة جد هامة في يد المنظمة، وتتمثل أهميته فيما يلي:
- التكوين كوسيلة للتنمية : نظرا للتطور السريع للتكنولوجيا يرى المختصون أن مستقبل المنظمة يكمن في التكوين لعمالها، فالمنظمة تخصص فضاءا كبيرا لتحسين حجم ونوعية العمل، تقليل تكاليف الإنتاج، رفع معنويات وتحفيز عمالها. فهي تسمح لهم بالدخول في وظائف جد مهمة، وتجعلهم جاهزين لاستعمال كفاءاتهم. إذن التكوين هو وسيلة للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والتأمين على فقدان الوظائف وعدم تأقلم الفرد بعمله.[6]
- التكوين كنشاط مربح : تستثمر المنظمة في التكوين من أجل أن تحقق منه عائد، فالمنظمة تخصص ميزانية للتكوين تشمل مختلف التكاليف، بغض النظر عن إمكانية قياس هذا الربح. فللتكوين آثار قد تتمكن المنظمة من قياسها) زيادة رقم الأعمال،…( وهناك آثار أخرى يصعب قياسها نظرا لتداخلها مع أنشطة ومتغيرات أخرى)الرضا الوظيفي…(.
- أهداف التكوين:
قد أشار Lakhdar Sekiou إلى أهداف التكوين في عناصر عدّة وهي : [7]
- ضمان الملاءمة بين قدرات ومعارف العمّال.
- تكييف العمال لمهام محددة وللتغييرات في الوظائف.
- المحافظة على درجة كفاءة ضرورية في تطوير المنظمة.
- تحسين هيكلة العمالة عبر الترقية في المنظمة.
- الوصول إلى فعالية كل الموظفين الجدد عن طريق الاستعمال الأفضل للوسائل والمعدات والتقليص من حوادث العمل.
- المساهمة في برامج وسياسات جذب الموارد البشرية.
- تحقيق أفضل تعامل في العمل وتشجيع التصرفات الايجابية التي تسمح بتقليص التكاليف وخسائر الإنتاج، وكذا تحسين نوعية وكمية المنتجات.
- تنمية روح تقدير الذات لدى كل عامل.
- المساعدة في تنمية مبدأ الحيطة وحماية العمال.
- مساعدة العاطلين عن العمل في الاندماج بسهولة في منظمات جديدة.
- تشجيع العاملين على الإفصاح وإبعاد الضغط والخوف.
- التكيف مع متطلبات المحيط الذي يتميز بالتغير.
- تنمية قدرات التحكيم والتمييز لدى المتكونين.
- سيرورة عملية التكوين:
- تحديد الاحتياجات التكوينية:
- مفهوم الاحتياجات التكوينية: يعرف الاحتياج التكويني بأنه “ظاهرة تعكس وجود قصور في أداء الفرد الحالي أو المتوقع نتيجة نقص في المعارف والمهارات والاتجاهات”[8]،
وتنشأ الحاجة إلى التكوين بسبب تغييرات طرأت في المنظمة، استقطاب عمال جدد، إدخال تكنولوجيا حديثة نتيجة لتقييم برامج التكوين السابقة.
وتعرف عملية تحديد الاحتياجات التكوينية على أنها : “مجموع التغيرات والتطورات المطلوب إحداثها في معلومات ومهارات واتجاهات وسلوك العاملين للتغلب على المشاكل التي تعترض سير العمل أو الإنتاج أو تعرقل تحديد الأهداف الإستراتيجية للمنظمة”.[9]
ويعبر عن الاحتياجات التكوينية على الشكل التالي:
ما هي الوضعية الحالية؟
ما هي الوضعية المأمولة؟
ما هي الأهداف الواجب تحقيقها؟
الفارق
Source : Guide de Gestion des Ressources Humaines, Techno compétences, Québec, 2003, p87.
ولتحديد الاحتياجات التكوينية أهمية بالغة تتمثل فيما يلي:[10]
- توفير معلومات أساسية لوضع خطط التكوين.
- التحديد الدقيق لأهداف التكوين.
- تصميم برامج تكوين موجهة للنتائج.
- تحسين كفاءة وفعالية التكوين.
- تحديد الصعوبات ومشاكل الأداء التي يعانيها العاملون في المنظمة.
- يساعد المكونين على تصميم برامج تلبي احتياجات المتكون بدقة.
- تجنب الأخطاء الشائعة في التكوين مثل: الوقت، التخصص، ….الخ.
- طرق تحديد الاحتياجات التكوينية:
يمكن تلخيص أهم الطرق لتحديد الاحتياجات التكوينية إلى ثلاثة طرق رئيسية ومتكاملة وهي:
- تحليل التنظيم أو المنظمة.
- تحليل العمل أو الوظيفة.
- تحليل الفرد.
إن التحديد الدقيق للإحتياجات التكوينية يتم عن طريق التحليل الدقيق لهذه العناصر، فتحليل التنظيم يساعد المنظمة في تحديد المواقع أي الإدارات والأقسام والمصالح الواجب تكوين أفرادها، وتحليل العمل(الوظيفة) يساعد المنظمة في تحديد محتوى ونوع التكوين، أمّا تحليل الفرد يأتي تكملة لتحليل التنظيم والوظيفة ليحدد الأفراد الواجب تكوينهم.
- تصميم البرنامج التكويني:
يرتبط تصميم البرنامج التكويني بتحديد الشكل النهائي للبرنامج، أي تحديد المواد التكوينية، وأساليبها، ومساعداتها، والشروط الواجب توافرها في المتكونين، واختيار المكونين المناسبين، واختيار المكان المناسب، وأيضا الزمان الملائم، وأخيرا تصوير الموازنة التقديرية.[11]
وفيما يلي عرض لمختلف النقاط الواجب على مصمم البرنامج التكويني أخذها بعين الإعتبار:
- تحديد أهداف ومحتوى البرنامج التكويني.
- إختيار الطرق والأساليب التكوينية.
- تحديد زمان ومكان التكوين.
- اختيار المكوِّنين والمتكونين.
- وضع الميزانية التقديرية للتكوين.
- تنفيذ البرنامج التكويني: يتوجب على مدير التكوين أو المعني بتنفيذه أن يضمن مطابقة التنفيذ مع ما هو مخطط مسبقا، أي ضمان ما يلي:
- مطابقة الجدول الزمني مع التوقيت الموضوع في خطة التكوين.
- جاهزية وملاءمة مكان التكوين.
- جاهزية وملاءمة المساعدات والأساليب التكوينية.
- حضور المكونين والمتكونين المعنيين.
- مطابقة المحتوى والموضوعات المدرّسة مع ما هو مخطط.
- سيرورة البرنامج نحو الأهداف المخطط لها.
- المتابعة اليومية لسير البرنامج.
- تقييم البرنامج التكويني:
“التقييم مرحلة جوهرية في عملية التكوين”[12]، لذا يجب أن يحقق تقييم التكوين ما يلي[13]:
- معايير إحصائيه لتقييم فعالية التكوين.
- التحقق من مدى نجاح التكوين في التطوير والتعديل.
- المساهمة في إكتشاف الأداء المبدع للأفراد وتنميته.
- وضع نماذج تكوينية للتفكير الصحيح تجاه المشكلات.
ويفهم مما سبق أن يتضمن التكوين وضع المعايير للأداء الفعال في ضوء مقياس أداء المتكون الفعلي وما هو متوقع منه مقارنة بالمعايير العالية الأداء.
حسب Piérre Massot و Daniel Feisthamel:” هدف التقييم هو التأكد من أن التكوين سمح بتحقيق أهداف المنظمة وكذا أهداف جهاز التكوين، بعبارة أخرى أن التكوين كان فعالا”.[14]
فيما يلي عرض لجدول يبين مختلف أنواع التقييم وكذا الأطراف المعنية بها:
الجدول رقم (01): التقييم متى, لماذا, بمن
| التقييم متى, لماذا, بمن | ||
|---|---|---|
| متى | طبيعة التقييم | من |
| قبل التصميم | تقييم الاحتياجات | المصالح والموارد البشرية |
| أثناء التسجيلات | تقييم عند الطلب | إدارة الموارد البشرية |
| أثناء الافتتاح | تقييم التوقعات | المنشط |
| أثناء التنفيذ | -تقييم المكاسب -تقييم الأهداف -تنظيم العلاقات | المنشط |
| عند الختام | تقييم الرضا | المنشط + الموارد البشرية |
| فيما بعد | تقييم الفعالية | الموارد البشرية والمصالح |
| وأخيرا | تقييم النجاعة | الموارد البشرية، مديرية الإدارة و المالية، الإدارة العليا |
La source: Parmentier Christophe, l’essentiel de la formation, Ed d’organisation, paris 2003, p223
________________________
1. Sekiou Lakhdar, Gestion du personnel, Edition d’organisation, Paris, 1986, P293. ↑
2. د محمد سعيد سلطان، إدارة المواد البشرية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 183. ↑
3. الدكتور محمد حافظ حجازي، إدارة الموارد البشرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2008 ، ص 310. ↑
4. Soyer Jaques, Fonction Formation , Edition d’organisation, 1998, Paris, p13. ↑
5. DIMITRI Weiss, Les Ressources Humaines, Edition d’organisation, Paris, 2000, P437. ↑
6. SEKIOU Lakhdar, Gestion du Personnel, Edition d’organisation, 3 eme Edition, Québec, 1990, p293 ↑
7. SEKIOU Lakhdar, Op Cit, p292. ↑
8. سعد الدين خليل عبد الله ، إدارة مراكز التدريب، مجموعة النيل العربية، ط1، القاهرة، 2007، ص 125. ↑
9. عادل محمد زايد، إدارة الموارد البشرية رؤية إستراتجية، القاهرة، ، 2003، ص 297. ↑
10. نجم العزاوي، جودة التدريب الإداري، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2009، ص ص 187-188 ↑
11. محمد حافظ حجازي، مرجع سابق، ص 320 ↑
12. KOHEN Annick, Toute la Fonction Ressources Humaines, Dunod, Paris, 2006, P268 ↑
13. رأفت السيد عبد الفتاح، سيكولوجية التدريب وتنمية الموارد البشرية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2001، ص 154 ↑
14. MASSOT Piérre FEISHAMMEL Daniél, Pilotage des Compétences et de La Formation, Edition ANFOR, Paris, 2001, P157. ↑
