تستعرض منهجية البحث في النحو والبلاغة جهود العلماء الليبيين بين 1950 و2000، كاشفةً عن إسهاماتهم الفريدة في البحث اللغوي. كيف أثرت هذه المناهج على تطور الدراسات اللغوية في المنطقة؟ اكتشف التفاصيل في هذه الدراسة المتميزة.
تتناول هذه الدراسة جهود العلماء الليبيين في مجالات النحو والبلاغة خلال الفترة من 1950 إلى 2000، وتسلط الضوء على إسهاماتهم في البحث اللغوي. كما تستعرض الدراسة المناهج والموارد المستخدمة في تلك الأبحاث.
جامعة باتنة
والعلوم الإنسانية
الآداب
كلية
وآدابها
العربية
اللغة
قسم
ليبيا
في
النحوية والبلاغية
الجهود
في النصف الثاني من القرن العشرين
مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في اللغة
الجزء الأول
أطروحة
إشراف
أبو غنيمة.
إعداد : أمحمد علي
الأستاذ الدكتور : السعيد هادف.
العام الدراسي 2006/2005م
فأمّا الزبدُ فيذهبُ جُفاء وأمّا ما ينفعُ الناسَ فيمكثُ في الأرضِ
كذلك يضربُ اللهُ الأمثالَ
صدق الله العظيم
سورة الرعد الآية19:
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية
Grammatical and Rhetoric research in Libya During the Second Half of the Twentieth Century.
By. Emhimmad Ali Abu-Ghnaima
An Abstract
Praise be to God, the Cherisher and Sustainer of the Worlds.
Researching the scientific endeavours of early scholars is one of the research areas that should be targeted by contemporary researchers. That is because contemporary research is often based on the findings of earlier studies.
Consequently, this study aims at:
- triggering out the linguistic research in Libya during the period from 1950 till the year 2000.
- highlighting the contributions of Libyan scholars in linguistics and rhetoric.
- Analysing the publications of Libyan linguists along this span of 50 years focusing on their methodologies, data and resources.
This study is divided into an introduction and four chapters. In the Introduction, the political, economic and cultural conditions that Libya had experienced will be discussed. The period covered by the study will be sub-divided into the monarchy and the republic phases. This division is related to the political, economic and cultural changes and the consequential developments in the life of the Libyan society.
Chapter One is dedicated for textbooks at schools and university levels. Samples of those textbooks were analysed and discussed. Chapter Two is dedicated to Arabic grammar which was divided into two topics, a) the history and scholars of Arabic grammar b) Applied research in Arabic grammar
Chapter Three : manuscript editing.
This chapter is dedicated to the discussion of manuscript editing. A number of manuscripts were surveyed and their particulars were taken down. Chapter Four is dedicated to rhetoric analyses which was divided into two sections; a) general rhetoric topics, and b) manuscript editing in rhetoric studies.
Findings of the study.
- Libyan linguists have positive undeniable contributions in the field of linguistic research in spite of the difficult circumstances they experienced between 1950 and the year 2000.
- The works of Libyan linguists are characterised with correct selection of topics and good presentation. It is also well suited to the age groups of pupils and students despite the fact that some of these works gave priority to quantity (some books are of more than 300 pages).
- Most of the textbook authors adopted a classical approach to the linguistic research. That is because the researchers have not encountered any work based on the principles of modern linguistic research.
- It is a shared belief among Arab grammarians that the authenticity of linguistic research is measured by its reliance on the works of classical grammarians. This has oriented the works of Libyan grammarians who have, more or less, adopted this approach rather than employing the findings of modern linguistic research.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
مقدمة
الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فإن الموروث الثقافي والحركة الفكرية هما نبض الأمة، والمُرشد الذي
يدل على إسهامات علمائها في بناء مجدها الحضاري، فالدول لا تقوم إلاّ
على عواتق رجال الفكر والعلم؛ لأنهم هم عيونها وكنز تراثها، وأزمنتهم
القادمة، وهم الذين ينحتون التاريخ ومسار المستقبل، ويجعلون من أيامهم
شيئاً مبهجاً، والفكر البشري هو الذي يرقّيها ويهديها، وينير لها الطريق،
ويمهد لها السير في سبيل السلامة، ومن دون ذلك لا يرقى شعب، ولا
يمكن أن تقوم له دولة.
والاعتناء بالتراث الإسلامي الزاخر بمختلف العلوم والمعارف،
والكشف عن جهود الآباء والأجداد، أمرٌ يحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ من أجل
الوصول إلى نتائج علميةٍ تساعد على الاستفادة منه حاضراً أو مستقبلاً،
والتعريف بالمؤلفين العرب الليبيين وإنتاجهم في المجالات المتعددة للمعرفة
الإنسانية يسهم بلا شك في تعزيز سياسة الارتباط بالعالم المعاصر وتشيد
الجسر الذي تعبره أفكار وآراء هؤلاء المؤلفين لتتفاعل مع غيرها من
الأفكار والمذاهب والنظريات، وإن أي إهمال في جوانب هذا التراث
الفكرية، أو الثقافية، يعد جناية على مقومات هذه الأمة، وقضاءً على
طموحاتها.
والفترة الزمنية الواقعة بين سنة 1950)ـ2000م ( شهدت جهوداً بذلت من
قبل العلماء الليبيين في مختلف مناحي المعرفة، وبخاصة فيما يتعلق بعلوم
اللغة، فهي فترة حركة وازدهار علمية، نتاجها العلمي ليس بالقليل فليست
ليبيا مجرد صحارى شاسعة، إنما ليبيا ثقافة وحضارة وتاريخ، وهي إحدى
حلقات الفكر الثقافي لما لها من تاريخ علمي وثقافي إلى جانب التاريخ
الجهادي والبطولي، مع التسليم بأن الدور الذي أسهم به الليبيون كان ـ
في الجملة ـ أقل مما أسهم به غيرهم، فلا يعني هذا أن جهدهم لا يستحق
الذكر، وانتاجهم لا يستأهل الدراسة أو أن ما قدموه مما يصلح إغفاله، أو
السكت عنه، ولهذا فإننا لا نرى معنى لإغفال من كتبوا عن الثقافة
العربية دور ليبيا الثقافي، والذي قام به العلماء الليبيون لا يعد عملاً علمياً
منفصلاً عما قام، ويقوم به العلماء في كل أقطار الوطن العربي، والعالم
الإسلامي، فهو يشارك ما كتب في مصر، وما كتب في لبنان والعراق
وغيرها، بل يعتمد عليه وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب اللغوية؛ لكونه
واحدة في كل أقطار الوطن العربي، فالنحو هو النحو في الجزائر أو في
ليبيا، والصرف هو الصرف في مصر أو في تونس، وإن وأخواتها في
المغرب أو في سوريا واحدة، وقد تم اختيار هذا الجانب لما فيه من
تعريف بالإنتاج العلمي والثقافي؛ والحياة الثقافية في ليبيا مازالت مجهولة
الأبعاد، مطموسة المعالم، وهو ما جعلها تحتاج إلى العديد من الدراسات
والأبحاث التي تسهم في بناء الثقافة وعلاقة هذه الدراسات بغيرها
وتأثيرها وتأثرها.
إن هذه الجهود لم تكن مقتصرة على الجانب النحوي أو الصرفي فقط،
بل تجاوزته إلى كل فروع اللغة وعلومها من: نحو، وصرف، وبلاغة،
وعروض، ومعاجم… وغيرها، فكل هذه الجوانب المعرفية في حاجة
ماسّة إلى الدراسة والتمحيص والمقارنة، ومعرفة مدى تأثيرها بالقديم،
ودورها في الحديث، وتقيمها تقيمًا علميًا في ضوء الدراسات العلمية الحديثة.
والقيام بهذه الدراسة عن ليبيا لا نعني بها تلك الإقليمية الضيقة
المتوقعة، أو ذلك الانفصال المدمر المقيد، بل نقصّد تسليط الضوء على
جوانب ربما خفيت على البعض، وإظهارها بمختلف جوانبها، وإمكانية
الاستفادة منها، وآن الوقت لكي تعرف، وتعلن للكل؛ لأن معنى الليبية هو
معنى العربية الإسلامية، فإذا قلت ليبيا، كان المفهوم هو العروبة
والإسلام، في هذه القطعة الغالية من عالمنا الواسع الرحب، ولا تعارض
على الإطلاق بين دراسة قطر من الأقطار على حدة، وبين دراسة الأقطار
ككل متكامل، ولنقل بعد هذا: إن ليبيا عضو في جسم، أفلا ينبغي أن
يدرس هذا العضو؟ أم ترانا ننبذ الأمر، وننفذ أيدينا منه، اكتفاءً بدراسة
الجسم كله، فإذا رأينا بعد هذا أن بقية أعضاء الجسم قد درست، ولا تزال
تدرس، علمنا أن الاهتمام بما هو أشد اتصالاً بنا، وأوثق ارتباطاً على
المدى القريب والبعيد، وليبيا العربية المسلمة، بنت الماضي البعيد، وهي
كذلك حاملة راية الإسلام والعروبة في مختلف العصور والأجيال، وهي
موطن لذكريات عزيزة على كل مسلم وعربي، ومسرح لنضال الأبطال العرب في شتى الأحداث، ومواقف الجهاد وميادين البطولة.
وقد يكون هذا النتاج العلمي في عمومه أقل مما هو في مصر، أو في
لبنان، أو في سوريا من حيث الكم، ولكن مهما قلّ فسوف يكون له الأثر
الفعال في إثراء الحركة العلمية بعامةٍ، والحركة اللغوية بخاصةٍ، حيث
أسهم في إرساء أصول الثقافة العربية والإسلامية، وما لها من دورٍ في
الحضارات العالمية، باعتبار أن الحضارات تترابط ترابطًا وثيقًا، ويكمل
بعضها بعضًا، فلا تنتهي بانتهاء الشهور والسنين، ولا تقف عند حد معين،
قد يحدث لها شيء من الضعف والذبول؛ ولكنها تستمر بذلك الضعف، وتراث الأمم هو جذورها وأسسها التي تبني عليها أمجادها وهو ما يجب أن تحافظ عليه.
وقد مزجت هذه الدراسة بين علمي النحو والبلاغة؛ لأن النحو دراسة
لنظم الكلام، وكشفٌ لأسرار تأليف التراكيب، وبيان لما يعرض له من
ظروف، وتوصل إلى ربط المعنى بالسياق، وعلم المعاني يدرس أساليب
التعبير في أحوالها المختلفة، وصورها المتعددة، بما يكون فيها من تقديم
وتأخير، وحذف وإظهار، وفصل ووصل وما إلى ذلك ليكشف عن أسرار
جمالها، وهذه المسائل بأعيانها من مسائل النحو، وكذلك فإن المفهوم من
كلام العرب والنحاة أن ما يسمى “علم المعاني” إنما كان من النحو، وقد
اختل النحو اختلالاً فاحشاً بفصله عنه؛ لأن تركيب الكلام مستند إليه
ومعتمد عليه، وهذا كله يدرس ضمن ما يسمى بالدراسة اللغوية بشكل عام،
وهكذا كانت العلوم اللغوية تخدم بعضها بعضاً، ولم تكن منفصلة عن
النحو، ولهذا نلاحظ أن سيبويه لم يحدث شرحاً بينهما، حيث أدرك أثر
نظام الكلمات، فراح يشرح العبارات التي حدث فيها تصرف بلاغي؛
لتوضيح الوجه الذي يستقيم عليه المعنى، كما يشرح الأساليب الكلامية بعلل نحوية وفقهية.
وتنحصر أهمية هذا الموضوع في نقاط منها:
1ـ· ما يتمتع به من قيمٍ علميةٍ وتاريخيةٍ، وما له حظّه الباحث من حاجة
ملحة لهذه المؤلفات والفوائد الجمة التي تتميز بها.
2ـ· عدم وجود الدراسات المتخصصة التي تقوم بتغطية الفترة الزمنية،
والمكانية التي اعتمدها هذا البحث.
3ـ· أضف إلى ذلك رغبة الباحث الأكيدة في الكتابة عن هذه الفترة، عليها
تمكنه من إضافة لبنة إلى لبنات الدراسات اللغوية.
ونظراً لأهمية تحديد عنصري الزمان والمكان لدراسة أي ظاهرة من
الظواهر، فإنني جعلت لهذا البحث إطارين زماني ومكاني:
فالزماني يبدأ مع بداية المنتصف الثاني من القرن العشرين، وتستمر حتى
العام 2000 من القرن نفسه، أي أن المدة الزمنية التي استوعبتها هذه
الدراسة كانت خمسة عقود؛ لأنه كلما ضاقت الفترة الزمنية استطاع
الدارس الإحاطة بالموضوع، وكلما اتسعت الفترة الزمنية، كلما صعبت
السيطرة على أي دراسة كانت، وفي أي مجال كان، وقد تم تحديد هذا
الوقت لهذه الدراسة؛ لارتباطها بحدثين مهمين غير مجرى الحياة في
ليبيا، الحدث الأول استقلال ليبيا وقيام دولة، وقد دامت هذه الفترة سبعة
عشر عاماً، والحدث الثاني قيام ثورة الفاتح من سبتمبر 1969م واستغرقت
هذه الفترة حدود الثلاثين سنة، وعلى الرغم من الجهود المضنية في
البحث عن مؤلفات في العشرين سنة الأولى ـ أو ما سمي في هذا البحث
بالفترة الأولى ـ فإن الباحث لم يتمكن من الحصول على شيء يذكر،
ولكنه اعتبرها الأساس الذي بنيت عليه كل تلك النتاجات في الفترة الثانية.
والمكاني يقتصر على النتاج العلمي في ليبيا فقط، ومقترنة بجهود عدد
من الشخصيات العلمية اللغوية، وتتبعا تتبعاً استقصائياً، وتفصيل القول
فيها تفصيلاً يليق بتلك الجهود وبتلك الفترتين الزمانيتين والمكانيين
المحددتين، وقد بنيت هذه الدراسة على أكثر من ستين مؤلفاً ما بين النحو
والبلاغة، وستقوم هذه الدراسة بإلحاق تراجم لهذه الشخصيات بشيء من
الإيجاز، ذلك أن موضوع البحث منصب على الجهود العلمية، أكثر من اهتمامها بمؤلفيها.
إن لكل دراسة علمية منهجاً علمياً يجب اتباعه؛ لأن لكل منها مجاله
الأساسي في البحث العلمي، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المناهج تتلاحم
وتتعاون من أجل الكشف عن الحقائق العلمية في دقة وموضوعية، فلا
غنى لأي باحث عن الإلمام بكل المناهج، والاستفادة منها في الدراسة بما
يحقق الغاية التي يرجو الباحث الوصول إليها، وعلى هذا لا يمكن في أي
دراسة، الاكتفاء بمنهج واحد، نظراً لتشابك العلوم في مناهجها،
وعدم إمكانية الفصل بين المناهج، لكونها في الأصل ترجع لمنهج واحد،
وعلى الرغم من كل ذلك، فقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي
الوصفى الذي يصف الظاهرة ويقرر فقط دون أن يصدر الأحكام
المعيارية، فهو منهج لغوي خالص يعتمد من ناحية الباحث على التجرد
من الذاتية والالتزام الموضوعية، ومن ناحية المادة المدروسة على الوصف
الشكي للأحداث فوظيفة الباحث وفق هذا المنهج لا تتعدى الوصف
الشكي للظاهرة، والمرد بذلك تتبع كل المؤلفات “النحوية والبلاغية” في
هذه الفترة، ووصفها علمياً مع ذكر بعض النصوص والآراء وشواهد
المؤلف قرأنا، وحديثاً، وشعراً، ونثراً، والمصادر التي اعتمد عليها، وقد
اتبعت في هذه الدراسة الأسلوب العلمي الواضح المعالم، محاولة الابتعاد عن
الذاتية، أو التدخل الشخصي، غير معتمد على الظن أو التخمين في
الوصول إلى النتائج؛ بل معتمداً على الاستقراء والوصف والتدقيق.
أما الدراسات السابقة حول هذا الموضوع فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن هذا
الموضوع لا يزال يتطلب عمقاً وسعة، لأنه حسب زعمي لم تقم أي دراسة
شاملة لكل ما ألف في هذا المجال، باستثناء دراسة واحدة على إحدى
شخصيات هذه الفترة، وهي رسالة “ماجستير” بعنوان: “إبراهيم رفيق
وجهوده اللغوية”، لكن هذا الموضوع “البحث” لا يقلل من قيمة هذه
الدراسة، ولا يؤثر فيها، بل يزيد من أهميتها؛ باعتبار أنه يمثل جزئية منها.
أما غير ذلك فلم أجد من أفرد كتاباً لدراسة هذا الجانب من الجوانب
الفكرية، في هذه الرقعة.
إن لكل دراسة علمية أهدافاً تقوم من أجلها، وهذه الدراسة لا تختلف
عن غيرها فهي ذات أهداف، وأهم أهداف هذه الدراسة هي:
–1 افتقار المكتبة العربية بوجه عام إلى هذا النوع من هذه الدراسات، وآمل
أن يكون هذا البحث لبنة تسد جزءاً من هذا الفراغ، أو لعله تدفع الباحثين
إلى هذا الميدان فيثرى بمزيد من الجهد والعمل المتواصل، خدمة للتراث
العربي في جميع مجالاته، وإلقاء الضوء على جوانبه المتعددة، وسبر أغواره العميقة.
2 ـ تجميع هذا التراث ودراسته، والاستفادة منه في جميع ميادين اللغة،
والاهتمام بالجانيين الثقافي والفكري، من أجل ربط الأصيل وتواصل
الحلقات، ومد الجسور، بدل الجفوة، أو الهوة التي يخلفها الإهمال والتغاضي.
3 ـ محاولة إماطة اللثام ـ ضمن الجهود العامة على التعريف بـ
الأعلام المغمورين ـ عن عدد من المجهودات والأشخاص التي اشتغلت في
صمت وتجرد، من أجل الرفع من مستوى العلم والمتعلمين في هذه البقعة من العالم الإسلامي.
5 ـ إيماناً بالمسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجيل ـ والباحث واحد منهم
ـ في الحفاظ على هذا التراث، فقد حاول الباحث جاهداً؛ أن يسهم بما
استطاع في إحياء هذا التراث، والحفاظ عليه؛ لأن الجديد لا يمكن أن يُبْنَى
بلا الاكتناء على القديم، أو الاقتباس منه، أو الاهتداء بنوره.
6 ـ تناسي أو تجاهل العديد من المؤرخين للحركة العلمية في ليبيا
وتطورها فلقد ظلم تاريخ الثقافة ومسار الإبداع في ليبيا، حيث يقف هؤلاء
المؤرخون قفزاً متعدداً هذا البلد الرائع، والوطن العربي المسلم، يكتبون
عن كل الأقطار والعصور، إلا ليبيا من الناحية الثقافية، إما جهلاً وعدم
إطلاع، وعدم معرفة، وإما إهمالاً وعدم مبالاة، وقد حاولت هذه الدراسة
إبراز الشخصية الليبية العربية، هذه الشخصية التي تعد مجهولة أو
كالمجهولة في جميع البلاد العربية.
7 ـ التعريف بالمصادر اللغوية “النحو والبلاغة” أو على وجه الدقة، أهم
هذه المصادر وأبرزها، وتسجيل حركة النمو والتطور التي مر بها التأليف
في هذين الميدانين، وسيتم تناول هذه المصادر من زاويتين:
ـ تناول التعريف بمؤلفه تعريفاً موجزاً في الهامش، ووصف منهج
الكتاب، وتحديد مجاله الموضوعي، مع بيان أغلب موضوعاته، ومجال
الانتفاع به، وطريقة هذا الانتفاع، وتقديم نموذج صغير منه ـ كلما
اقتضى الأمر ـ لبيان أسلوبه، وهذه الزاوية تخدم الفائدة العلمية.
ـ تحديد قيمته بوصفه حلقة في سلسلة تاريخية ممتدة، وتخدم هذه الزاوية
التصور العام لحركة تطور التأليف في هذه الفترة، وفي هذه البلاد.
وليس من مهام الباحث في هذا البحث التتبع التفصيلي لكل فرع من فروع
المعرفة؛ لأن ذلك يستحيل علاجه في رسالة دكتوراه واحدة، بل يحتاج
إلى مجلدات عدة تكون شبيهة بدائرة المعارف، إضافة إلى ما يحتاجه ذلك
العمل من وقت طويل، وما يحتاجه من باحثين في مختلف التخصصات،
لمعالجة كل واحد منهم المجال الذي يناسب تخصصه، كذلك ليس من شغل
الباحث مقارنة نتاج الليبيين بنتاج غيرهم في جميع فروع الثقافة التي
درسوا؛ لأن ذلك جهد أفراد يقسم العمل عليهم، لا جهد فرد، ولا أحب
أن أتحدث عن الصعوبات وعن الجهد المبذول في هذا العمل؛ ليقيني بـأن
المنصفين من القراء أفضل من يقدرون ذلك ولكن حسبى إن أذكر أن
نظراتي ونقداتي فيه تظل على الرغم مما بذلته من جهد متواضع سوف
لن تضيق بالنقد الهادف البناء.
ولما كانت أي دراسة تستمد خطوطها من واقع الأمور التي تعالجها، فقـد
تكونت هذه الدراسة في مضمونها العام من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب
وخاتمة، وكانت على النحو التالي:
المقدمة: وهنا قد تضمنت أهمية الموضوع وأهدافه، وإطاري الدراسة
الزماني والمكاني، والدراسات السابقة…
التمهيد: وقد عرضت فيه صورة الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في
ليبيا وأثرها في هذه الدراسة، وقسمته على فترتين الفترة الأولى من سنة
1950 ـ1969م، والفترة الثانية من 1969 ـ2000م وجاء هذا التقسيم بناء على
تغير أوضاع ليبيا السياسية، حيث شهدت الفترة الأولى مرحلة الاستقلال،
وشهدت الفترة الثانية مرحلة التغير من النظام الملكي إلى النظام
الجمهوري، وقد كان لهذين التغيرين الأثر الكبير في حياة الشعب الليبي
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ترتب على ذلك من تطور في جميع مناحي الحياة.
الباب الأول:
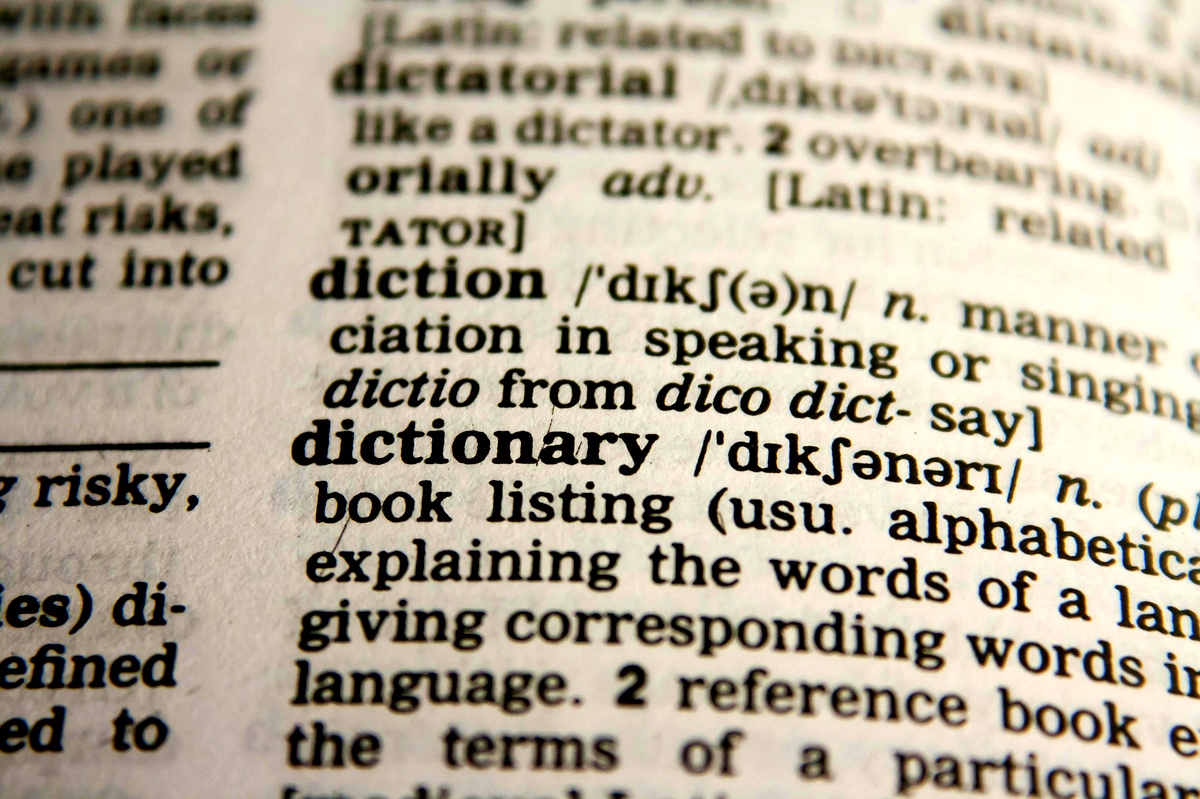
الموضوعات النحوية العامة.
الفصل الأول:
التاريخ للنحو وأعلامه:ـ
وقد جعلت هذا المبحث للحديث عن هذه الكتب والتي تدرس نشأة النحو،
كالقياس والتعليل ونتحدث عن بعض أعلام النحويين ومناهجهم وقسمته إلى مبحثين:
المبحث الأول:
القياس والتعليل والأصول. المبحث الثاني:
الشخصيات العلمية.
الفصل الثاني:
الموضوعات النحوية التطبيقية.
القرآن الكريم.
المبحث الأول:
الدراسات النحوية حول المبحث الثاني:
الدراسات النحوية حول الشعر العربي. المبحث الثالث:
موضوعات متنوعة.
الباب الثاني
تحقيق المخطوطات والتأليف في المناهج الدراسية.
الفصل الأول:
تحقيق نصوص التراث النحوية:ـ
خصصت هذا الفصل لدراسة الكتب التي اتجهت نحو تحقيق النصوص
التراثية، وقد كان الغالب في هذه الكتب الأصل فيها رسائل وأطروحات
للحصول على درجات علمية، وقد تأكد لدي أن منهج هذه المؤلفات قد
سار على فلك واحد، باعتبار أن منهج التحقيق يكاد أن يكون منهجاً واحداً
ومتفقاً على أغلب خطوات السير فيه، ولذلك يعد منهج التحقيق على الرغم
من أهميته وحاجتنا إلى تلك الكتب المحققة وحاجة هذه الكتب إلى الظهور
والانتشار إلا أنه يعد أحد المناهج التقليدية القديمة.
الفصل الثاني
التأليف في المناهج الدراسية النحوية.
خصصته لاستعراض نماذج من المؤلفات في المناهج الدراسية متتبعاً
المراحل الدراسية ابتداءً من المرحلة الابتدائية والتي لم تشمل على هذه
المرحلة كاملة، بل إن ذلك اشتمل على السنتين الأخيرتين منها؛ لأنها قد
وضعت لها منهج اشتمل على مفردات وبعض الموضوعات النحوية، وإن
كانت هذه الموضوعات مختصرة جداً مراعاة لأحوال وظروف طلبة هذه
المرحلة وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:
الأساسية. المتوسطة.
الجامعية.
الباب الثالث:
الموضوعات البلاغية العامة
الأول: المرحلة
الثاني: المرحلة
الثالث: المرحلة
المبحث المبحث المبحث
نظراً لارتباط فروع اللغة العربية الارتباط الوثيق وبخاصة النحو
والبلاغة فقد خصصت هذا الباب للحديث عن الكتب التي ألفت في
الموضوعات البلاغية، واشتمال هذا الباب على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الموضوعات البلاغية:ـ
خصصت هذا الفصل للحديث عن العديد من هذه الكتب التي تمكنت من
الحصول عليها ـ وإن كانت قليلة جداً ـ والتي توجهت نحو دراسة ما
يتعلق بالعلوم البلاغية بفروعها الثلاثة.
الفصل الثاني:
تحقيق المخطوطات البلاغية:ـ
جعلت هذا الفصل للحديث عن الكتب التي اتجهت نحو تحقيق النصوص
التراثية في العلوم البلاغية.
الفصل الثالث:
التأليف في المناهج الدراسية البلاغية:ـ
خصص هذا الفصل للحديث عن الكتب المؤلفة في المناهج الدراسية.
المبحث الأول:
المرحلة المتوسطة. المبحث الثاني:
المرحلة الجامعية.
الخاتمة:
وقد تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وأهم التوصيات من
خلال هذا الجهد.
المصادر والمراجع:
اعتمد هذا البحث على عدد كبير من المصادر والمراجع يمكن تقسيمها
إلى قسمين : مصادر ومراجع ودوريات أولية، وأطلقت عليها هذا اللفظ؛
لأنها المحور الذي تقوم عليه، وتدور حوله هذه الدراسة، وقد بلغت هذه
المصادر أربعين مصدراً، ومصادر ثانوية سيتم إلحاقها في آخر الرسالة.
كما أشير إلى أن المصادر عند ذكرها للمرة الأولى تذكر معلوماتها
كاملة في الهوامش، اسم المصدر، واسم المؤلف والصفحة والجزء، ومكان
ودار النشر وسنتها، أما عند ذكرها في المرة الثانية فإنه يكفى بذكر اسم
الكتاب والمؤلف، والصفحة والجزء إن كان هناك أكثر من جزء للكتاب
دون ذكر باقي المعلومات المتعلقة بالكتاب؛ وذلك للتخفيف على القارئ،
وعدم إثقال الهوامش بتفاصيل لا يمكن الاستغناء عن ذكرها في الثبت الخاص بالمصادر والمراجع.
كما أنني خرجت الشواهد القرآنية الواردة موضحاً اسم السورة ورقم
الآية، كما خرجت الأحاديث النبوية من كتب الأحاديث الأمهات، ونسبت
الإشعار إلى قائلها ما وجدته إلى ذلك سبيلاً، ذكرًا مصادر ورودها في
الدواوين وكتب أمهات اللغة.
ترجمت لكل الأعلام الواردة عند ذكرها للمرة الأولى أما إذا تكررت
أكثر من مرة فلا أترجم لها وقد جعلت ملحقاً للعديد من الرسائل العلمية
الماجستير والدكتوراه التي نوقشت في بعض الجامعات الليبية في الفترة
الزمنية نفسها وأضفت إليها ما تمكنت من الحصول عليه بعد هذه الفترة من
خلال العديد من المجلات والدوريات العلمية.
وأخيراً أقول كما قال محمد الصادق عفيفي: “مددت سمعي وبصري،
وأدليت بدلوى في بئر لما يعرف غورها، حتى قال بعضهم مالك وهذه
وهل يوجد في
آخرون:
وقال
(1)؟
معالم”
التركة المثقلة التي لا يعرف لها ليبيا ثقافة أو علم أو تأليف؟.
ويعلم الله ما بذلت من الجهد والعناء في سبيل إخراج هذا العمل، لولا
رعاية الله وتوفيقه لضلت السبيل ولغابت عني أعلام الطريق، ومع ذلك
لا أشك في وجود هفوات وعثرات، عذري في حداثة التجربة وليون
الخبرة في ميدان لا يسارع فيه إلا الكبار، ولا يحسن إتقانه إلا الصيارفة
الجهابذة، كما لم تخل مراحله من الصعوبات ومشاق وعراقيل خشيت
معها تنوين العزم وتخذيل الهمّة.
بالمرء نبلاً أن تعد معايبه(2)
كفى
ومن ذا الذي تعرض سجاياءه كلها
وأخلصت النية لله.
الجهد
أني بذلت
وحسبي
إلا بالله(
توفيقي
)وما
